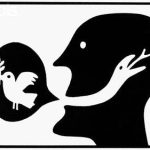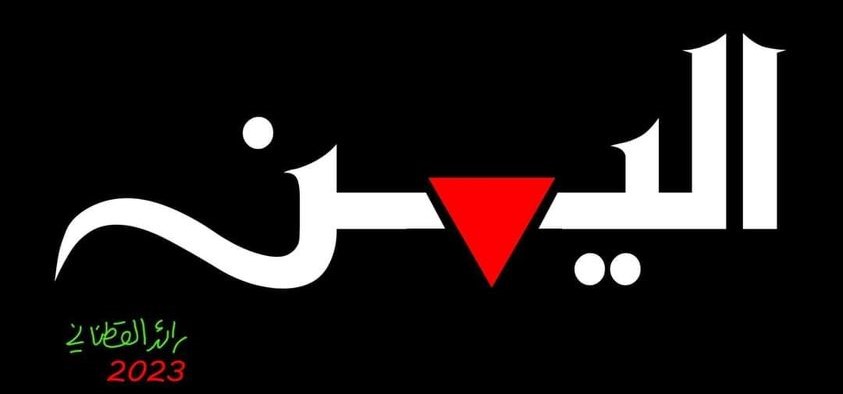د. إبراهيم علوش
(مساهمة في مؤتمر رابطة الكتاب الأردنيين حول التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في 2/2/2013)
كان قد طلب مني الزملاء الكرام أن أكتب عن التمويل الأجنبي والتطبيع. لكن أستميحكم عذراً في البداية أن أتناول السياق العام الذي يمكن من خلاله أن نربط بينهما. إذ لا يمكن أن نتحدث عن العلاقة بين التمويل الأجنبي والتطبيع بدون تناول مفهومين أساسيين: أولهما هو مفهوم العولمة، وثانيهما هو مفهوم “الشرق أوسطية”.
أما بالنسبة للعولمة، فإذا أردنا أن نقدم تعريفاً معلباً سريعاً لها، يمكن أن نقول بأنها تمثل اندماج الاقتصادات المحلية والوطنية والإقليمية في شبكة عالمية واحدة، وهو ما يتمثل بتزايد حركة رأس المال والسلع والخدمات والأفراد والمعلومات والتأثيرات الإعلامية والثقافية عبر الحدود. وقد كانت رافعة العولمة الشركات متعدية الحدود التي تستثمر وتعمل وتتاجر وتوظِف عبر دول مختلفة. وفيما بين تلك الشركات، كانت الحلقة المركزية ما يسمى برأس المال المالي الدولي الذي يتمثل بسيطرة رأس المال الربوي والمضارب على الإنتاج وعلى التجارة الدولية.
وقد تعمقت في ظل العولمة علاقة غير متكافئة ما بين حفنة من المراكز ومحيطٍ من الأطراف هي علاقة تبعية الأطراف للمراكز بالضرورة.
الأهم من هذا أن عملية العولمة أنتجت برنامجاً جديداً في دول المركز، ولدى الشركات متعدية الحدود، بات يتطلب إضعاف الدول المركزية على أشكالها، حتى تلك التابعة للامبريالية منها، وإعادة إنتاج الجغرافيا السياسية على أسس جديدة ترتكز على الهويات الفرعية الطائفية والمحلية والإثنية والعرقية والجندرية وإلى ما هنالك…
وهكذا صرنا نرى المؤسسات الاقتصادية الدولية، من صندوق النقد الدولي إلى البنك الدولي إلى منظمة التجارة العالمية، التي انطلقت رسمياً في 1/1/1995، كنتيجة للغات، أو الاتفاقية العامة للتجارة والجمارك، تركز على إضعاف الصلاحيات الاقتصادية للدول، أي دول، حتى تلك الموجودة في أوروبا الغربية وشمال أمريكا، وما الاتحاد الأوروبي إلا إضعافاً لهيمنة الدول القومية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا الخ… على حدودها.
وهكذا بات تقويض سيادة الدول ومشروعيتها وصلاحياتها جوهر الأجندة المعلنة للشركات متعدية الحدود، وباتت المؤسسات الاقتصادية الدولية هي المعنية بتنفيذ تلك الأجندة، وقد فرض موضوع الخصخصة، وموضوع إنهاء دولة الرعاية الاجتماعية، حتى في الغرب، على أرضية تلك الأجندة.
لكن تنفيذ تلك الأجندة ترك فراغاً. فانسحاب الدولة من حيز الاقتصاد، ومن حيز المجتمع، بات يتطلب جهة أخرى، لا تمثل حكومة معينة، بملء ذلك الفراغ من أجل تحقيق استقرار نظام العولمة. لأن قوى العولمة إذا قامت بإجراءات تفكيك الدولة الوطنية بدون صمام أمان فإن ذلك قد يؤدي إلى ثورات يمكن أن تتجه اتجاهاتٍ ثوريةً، نحو التنمية المستقلة والتحرر الوطني مثلاً، وهو ما سوف يخرب كل مشروع العولمة… ومن هنا بدأ التركيز على دور ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية، ومنظمات التمويل الأجنبي، في سياق خطاب ما يسمى “المجتمع المدني”.
وفي دراسة مصطلح “المجتمع المدني” كما يُطرح في الغرب، ولا نتحدث عن رؤية ثورية الآن، يُقال أن المجتمع المدني هو كل ما ليس دولة وليس قطاعاً خاصاً. وعلينا، حسب هذا التعريف، أن نستثني الأحزاب السياسية من هذا “المجتمع المدني”، لأنها تسعى للوصول للسلطة، باستثناء بعض المنظمات الحزبية القاعدية المنتشرة في الأرياف والجامعات ربما، فتلك يمكن اعتبارها مجتمعاً مدنياً، كما يجب حسب التعريف نفسه مثلاً أن نستثني المصارف والبنوك من “المجتمع المدني”، لأنه قطاع خاص.. دون استبعاد الغرف التجارية واتحادات رجال البنوك أو رجال الأعمال، التي تشجع مصالح السوق، تماماً من تعريف “المجتمع المدني”.
أحد المصادر المتوفرة بالعربية التي تتبنى التعريف أعلاه مثلاً دراسة “المجتمع المدني الكوني”، التي وضعها جان آرت شولت، الموجودة في كتاب “الاقتصاد السياسي للعولمة”، من تحرير نجير وودز وترجمة أحمد محمود، وهو كتاب صدر عن المشروع القومي للترجمة في مصر عام 2003، من إصدار دار ماكميلن بلغريف في لندن في 7/7/2000 تحت عنوان The Political Economy of Globalization.
إذن هذا هو تعريفهم لماهية “المجتمع المدني”، وهو تعريف منسجم مع الفكرة التي نقدمها هنا بأن انسحاب الدولة من حيز الاقتصاد والمجتمع بات يتطلب صمام أمان، سياسي وظيفياً، ولو قدم نفسه بصورة غير سياسية. وقد تمثل هذا الصمام بمجموعة من المنظمات غير الحكومية التي دخلت على الخط للإمساك بالقوة المجتمعية التي انسحبت الدولة من تغطيتها. وهذا يحقق أكثر من هدف في آنٍ معاً. فهو، من جهة، يحقق استقرار النظام العولمي ككل، وليس استقرار النظام المحلي طبعاً، لأن المطلوب هو زعزعة استقراره وخلق قوة موازية له. ومن جهة أخرى، فإنه يوجه الاحتجاج باتجاه مسارب آمنة بالنسبة للعولمة. ومن جهة ثالثة، فإنه يؤدي إلى خلق شبكة معولمة ترتبط بالخارج وتجزئ القضية الوطنية إلى قضايا تتعهدها منظمات التمويل الأجنبي الممولة من الخارج من أجل ترقيع مساوئ النظام.
ومن يريد أن يدرس ظاهرة منظمات التمويل الأجنبي فإن عليه أن يمسك بالمسألة من زاوية دور تلك المنظمات في المشروع الكبير. فهي منظمات تتناول الجزئيات لتهمش الكليات، فهي يمكن أن تقوم بمشروع للأطفال، للبيئة، إلى آخره… وربما يشير البعض إلى بعض الجوانب الإيجابية في تلك البرامج، ولكن المشروع أكبر من أجزائه بكثير. مثلاً فيما مضى، عندما كانت توجد أحزاب وطنية وقومية ويسارية فاعلة، كنت ترى في برامجها بنوداً تتعلق بالمرأة أو بالأرياف، وبكل تلك القضايا التي تتعهدها اليوم منظمات التمويل الأجنبي، ولكن ميزة تلك الأحزاب والرؤى، سواء اختلفت معها أم اتفقت، كانت أنها تضبط تلك الأجزاء في كلية واحدة هي القضية الوطنية أو القضية القومية أو القضية الطبقية. أما منظمات التمويل الأجنبي، التي لا تريد أن تعتبر الاحزاب السياسية جزءاً من مجتمعها المدني، كما جاء أعلاه، والتي أدت في بعض الحالات لتهميش الأحزاب والفكرة الحزبية، فإنها تسعى إلى تفكيك القضية الوطنية إلى شذرات يسهل بعدها أن تتحول إلى تفاصيل تقنية يمكن توظيفها في ترقيع المشروع الكبير، مشروع العولمة، من زاوية إصلاحية. إذن نراها تلعب دور فصل القضايا الجزئية عن الإطار الوطني والقومي العام الذي يصب في مشروع تحقيق التغيير الجذري في المجتمع.
وتطرح منظمات التمويل الأجنبي قضايا مهمة بالتأكيد، ولكنها ليست دوماً القضايا الأهم، بل غالباً ما تكون القضايا التي تبعدنا عن التناقض الرئيسي في المرحلة التاريخية الراهنة. فنحن مجتمعات تعاني اساساً من التجزئة والاحتلال والتخلف والتبعية، ومنظمات التمويل الأجنبي مهمتها إدارة عوائق الاحتلال والتجزئة والتبعية، وليس طرح مشكلة التناقض الرئيسي باعتبارها مشكلة تبعية واحتلال وتخلف وتجزئة.
ثم أن تلك المنظمات تحاول أن تؤسس نموذجاً محلياً، وأن تزرع نخباً ممتدة محلياً، مرتبطة بالخارج، ليس فقط من الناحية المالية والتنظيمية، إنما من الناحية الثقافية أيضاً. وأهم ما في تلك المنظمات أنها تنتج جيلاً جديداً ممن تسميهم قادة أو مثقفين تقولبوا فكرياً وأيديولوجياً في الفكر الليبرالي، حتى لو أسموا أنفسهم إسلامويين أو “إسلاميين”.
ثم أن هناك موضوعة المزاحمة على ملء الفراغ الذي يمكن أن يملأه الخط الوطني والقومي الثوري. فما دامت هناك مظالم تنتج عن العولمة، وما دامت هناك ضرورة لإدارتها بطريقة تؤمن استقرار النظام، من المهم أن يتم استقطاب عناصر النشطاء والمثقفين والمسيسين والثوريين والقادة والكتاب الذين يمكن أن يربطوا تلك المظالم في مشروع تغيير حقيقي. ولا بد من استقطابهم فرداً فرداً، والعمل على توظيفهم في المشروع الكبير، مشروع الاندماج بالعولمة.
هذا في ما يتعلق بالعولمة بشكل عام، ودور منظمات التمويل الأجنبي فيها، ولكن ثمة موضوعة آخرى لا بد من من ربطها بمسالة التطبيع وهي موضوعة “الشرق أوسطية” في بلادنا، أي في الوطن العربي، وهو الوطن العربي بالمناسبة وليس “العالم العربي”.
في بلادنا توجد حركة صهيونية ودولة محتلة غاصبة اسمها الكيان الصهيوني. فإذا ربطنا ما بين العولمة، من جهة، كما عرّفناها في البداية، وبين الصهينة، من جهة أخرى، فإن ما ينتج عن ذلك الربط هو مشروع “الشرق أوسطية”. “الشرق أوسطية” هي 1) مشروع تغيير هوية وثقافة المنطقة لضرب القاسم المشترك الجامع، و2) إعادة إنتاج الجغرافيا السياسية للمنطقة من خلال تفكيك الدول على أسس طائفية وإثنية وعرقية وجهوية وغيرها. ومن هنا تأتي خطورة من يتبنون قضايا الأقليات ضمن ذلك السياق تحديداً، أو من يتبنون قضايا “مظلومية الأغلبيات” (كما في العراق سابقاً، أو في سورية حالياً) على أسس طائفية. فهذا كله جزء من المشروع الصهيوني.
“الشرق أوسطية”، ويجب أن نضعها دائماً بين مزدوجين، هي العولمة زائد الصهينة، وتتمثل أكثر ما تتمثل بمنتدى دافوس، أو “المنتدى الاقتصادي العالمي”، الذي انتقل إلى الأردن بعيد احتلال العراق. وقد كانت المرة الأولى في تاريخه الذي ينعقد فيها سنوياً خارج مدينة دافوس السويسرية. وهو منتدى كبار مدراء الشركات متعدية الحدود في العالم، أي منتدى العولمة. وعندما انتقل إلى الأردن بذكرى تأسيس الكيان الصهيوني عام 2003، بعيد احتلال العراق تحديداً، كان ذلك نموذجاً لما يسمى “الشرق أوسطية”، أي للهجمة الساعية لتغيير هوية المنطقة وتهميش مفهوم العروبة وشطب القاسم المشترك ومفهوم التحرر الوطني في سياق التطبيع مع الكيان الصهيوني والانفتاح على الشركات المتعدية الحدود لاستباحة المنطقة بالكامل من قبلها.
سبقت الإشارة أن المنظمات غير الحكومية مهمتها إدارة العولمة ومساوئها وملء الفراغ الذي يتركه انسحاب الدولة وتأسيس نموذج ليبرالي متغرب مرتبط بالخارج تنظيمياً ومالياً لقطع الطريق على أي تغيير ثوري حقيقي في بلادنا. أما في فلسطين فإن مهمة منظمات التمويل الأجنبي أخطر بكثير لأن الاحتلال حسب القانون الدولي مهمته إدارة شؤون الأفراد والأشخاص والمجموعات الخاضعة للاحتلال، غير أن الاحتلال لا يريد أن يدير الاحتلال. فالاحتلال يريد احتلالاً بلا كلفة احتلال. ذلك هو الاحتلال الصهيوني. لذلك تم تأسيس سلطة أوسلو من جهة. ولكن ذلك لا يكفي وحده لأن مهمات سلطة أوسلو هي مهمات أمنية أساساً تتلخص بالحفاظ على أمن العدو الصهيوني. ومن هنا دخلت منظمات التمويل الأجنبي في فلسطين على الخط للقيام بالمهمات الذي كان يتوجب على الاحتلال أن يقوم بها. ومن ثم تجد متلقي التمويل الأجنبي يزايد: “يا أخي انت بتعطينا شعارات… احنا عم نعمل اشي ملموس… هي امبيولنس (سيارة إسعاف) أنا بنقل فيها الناس على المستشفيات عندما يحتاجون… أنا بقدم مساعدات!!”. هنا علينا أن ننتبه للسياق مرة أخرى. فالشيطان يكمن دوماً في التفاصيل، أما في حالة التمويل الأجنبي فإنه يكمن في الصورة الكبيرة قبل التفاصيل. فالمشروع برمته هو مشروع تخفيض كلفة الاحتلال على الاحتلال، وعلى السلطة الفلسطينية.
ولعل أحد أهم الأشياء التي تمكنت الامبريالية من تحقيقها، عندما فكرت بإعادة إنتاج الجغرافيا السياسية للمنطقة، وإعادة إنتاج هويتها وثقافتها، هو أنها استطاعت فصل خطابها عن خطاب الأنظمة العربية مقدمةً نفسها بذلك للشعب العربي باعتبارها مدافعة عن “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان”! وقد تمكنت بذلك من أن تنسي الناس دورها في تأسيس الكيان الصهيوني ودعمه، وفي تسويق ما يسمى “العملية السلمية”، وفي العدوان على العراق وعلى كل شعوب الأرض من أمريكا اللاتينية إلى فيتنام. وقد دعمت الإمبريالية الأنظمة التي تحقق مصالحها، فإذا استنزفت تلك الأنظمة غايتها وأصبحت هناك ضرورة لاستبدالها وتحديث اتفاقية سايكس-بيكو، قررت الامبريالية الأمريكية أن تستغل كراهية الشعب العربي لأنظمته بتقديم نفسها إليه باعتبارها المدافعة الأولى عن “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان”، وقد كان ذلك بموازاة بروز معارضات عربية تدعو للتدخل الأجنبي بذريعة “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان”. وهكذا دخل مشروع التفكيك “الشرق أوسطي” من أوسع أبوابه.
وتتأسس العولمة بنسختها العربية، أي “الشرق أوسطية”، من عدة بنود منها إضعاف الدول وتفكيكها، تفكيك الثقافة المحلية، إعادة إنتاج الهوية إلى هويات، والدول إلى دويلات، بالتوازي مع جعل الكيان الصهيوني كياناً طبيعياً مقبولاً في المنطقة. فإذا قلنا “شرق أوسطية” فإن وجود “إسرائيل” يصبح طبيعياً ومقبولاً، أما إذا قلنا وطناً عربياً فإن وجود الكيان الصهيوني لا يعود طبيعياً أو مقبولاً، وبالتالي فإن الأمن الحقيقي لدولة الكيان الصهيوني يتلخص بمشروع “الشرق أوسطية”. وما التسويات والمعاهدات إلا الجسر الذين يعبرون عبره من مرحلة السلام مع دول إلى السلام مع دويلات يهيمنون عليها… إلى “الشرق الأوسط الإسرائيلي”. وما منظمات التمويل الأجنبي إلا رافعة من روافع تحقيق ذلك المشروع. ولذلك فإن السياق العام للتمويل الأجنبي في بلادنا هو سياق تطبيعي بالضرورة.
ولنلاحظ بعض الأمثلة هنا… ولو أننا عندما نتحدث عن أمثلة علينا أن نذكّر أن ما نتحدث عنه هو رأس جبل الجليد، لأن الكثير مما يتعلق بالتمويل الأجنبي والتطبيع يتم في الخفاء. لكن ثمة ما يكفي من الدلائل والمعلومات المنشورة لكي نكون متأكدين بأن القوة الكامنة وراء التمويل الأجنبي هي نفسها القوة الكامنة وراء التطبيع. على سبيل المثال، لا تمنح مؤسسات فورد وروكفلر واليو أس ايد (الوكالة الأمريكية للتنمية) اعتماداتها، حسب الوثائق الخاصة بها حرفياً: “لأي مجموعة تدعو أو تولد التعصب أو العنف أو تمثل تهديداً لوجود وشرعية وجود دول شرعية وسيادية مثل إسرائيل”. وقد طُلب من متلقي التمويل الأجنبي في فلسطين التوقيع على وثائق من هذا النوع من قبل مؤسسات فورد وروكفلر واليو أس إيد. ومن المعروف طبعاً أن كل تلك المنظمات عليها أن توقع وثيقة التبرؤ من المقاومة والاعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ أي شكل من أشكال الكراهية تجاه الصهاينة وأن تقدم كشفاً بأسماء العاملين فيها وأن تخضع للرقابة المالية الأمريكية، وليست اليو اس ايد وحدها التي تتطلب توقيع مثل تلك الوثيقة.
ولنأخذ أمثلة محددة بالأسماء والأرقام يمكن إيجادها بسهولة على الإنترنت من قائمة أعدها د. محمد شرف وتم نشرها في 13/12/2007: مركز خليل السكاكيني الثقافي تلقى مثلاً 200000 دولار، وكان قبل توقيعه على الوثيقة قد أصدر أعمالاً معينة مؤيدة للانتفاضة، وبعد التوقيع على الوثيقة تغير تصرف المؤسسة بنسبة 180 درجة. مركز رواق، مركز المعمار الشعبي، تلقى 400000 دولار، وهي مؤسسة فلسطينية مختصة بأعمال الترميم والهندسة، وكان المركز المذكور قد وقع على الوثيقة أيضاً. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان تلقت 200000 ألف دولار، وهي مؤسسة موجودة في لبنان، وقد قامت تلك المؤسسة خلال حرب 2006 بإدانة “إطلاق حزب الله للصواريخ”، وادعت أنها عديمة الفائدة أو “عبثية”، و”أن حزب الله يطلقها من مناطق مأهولة” في عدة تقارير قدمتها للأمم المتحدة، وهي من المؤسسات التي تتلقى التمويل من مؤسستي فورد وروكفلر.
وهناك أيضاً مركز حقوق العاملين (ولاحظ اللعب على وتر العمال والبروليتاريا واليسار) الذي تلقى 200000 دولار من وكالة فورد. وكان المركز المذكور قد وقع على وثيقة مقاطعة وكالتي فورد واليو اس ايد ثم بلع توقيعه وتلقى ال200000 دولار. وهنالك أيضاً مركز القدس للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان الذي تلقى 100000 دولار بعد التوقيع على الوثيقة. ثم هنالك مركز مواطن للدراسات الديموقراطية الذي تلقى 180000 دولار مقابل قيامه بدراسات عن العلمانية والإسلام في فلسطين، ويذكر أن رئاسة تلك المؤسسة وقتها كانت تضم كل من د. عزمي بشارة ود. مصطفى البرغوثي. المنظمة الدولية للسلام تلقت 160000 دولار. وهنالك مركز بانوراما التابع للوزير السابق في السلطة الفلسطينية رياض المالكي الذي تلقى 90000 دولار من مؤسسة فورد وذلك لتمويل برامج قيادات شابة تجمع بين شباب فلسطينيين و”إسرائيليين”، وكان هذا المركز قد وقع أيضاً على وثيقة المقاطعة مع الجامعات “الإسرائيلية” ووثيقة مقاطعة التمويل الأمريكي ثم تلقى مثل ذلك التمويل..
الأمثلة كثيرة، وهي لا تقتصر على فلسطين، بل تمتد إلى الأردن ومصر على ما نعلم. فالتمويل الأجنبي “غير المشروط”، والذي تكمن مشكلته في الصورة الكبيرة ابتداءً، يتحول بصيرورته “الشرق أوسطية” بالضرورة إلى تمويل مرتبط بالتطبيع مباشرة بحكم السياق الذي يدفع الممولِين لمنح التمويل لتحقيق برنامجهم السياسي في المقام الأول، ولولا مثل ذلك البرنامج السياسي الإمبريالي لما جاء التمويل ابتداءً من الحكومات الغربية والشركات متعدية الحدود. فالتطبيع الكامن بالقوة يتحول إلى تطبيع كائن بالفعل في صيرورة تحقيق البرنامج الإمبريالي الصهيوني على الأرض، وهو ما لا يدركه، أو ما لا يريد أن يدركه، الساعي لتلقي التمويل الأجنبي عندما يخدع نفسه بأن ثمة تمويل “غير مشروط” مختلف عن “التمويل المشروط”!
وقد قرأت البعض، ممن احترمهم، وممن تعلمت منهم كثيراً على صعيد فهم ظاهرة التمويل الأجنبي، وهم يقولون بأن بروز منظمات التمويل الأجنبي في الساحة العربية عامة والفلسطينية خاصة ترافق مع توقيع معاهدات السلام مثل أوسلو ووادي عربة. غير أن هذا غير دقيق. الحقيقة أن الأمر بدأ قبل ذلك بكثير. صحيحٌ أن متلقي التمويل الأجنبي في فلسطين طفوا بصورة أوضح على السطح السياسي بعد المعاهدات الخيانية، ولكن العمل على ربط التمويل الأجنبي بالتطبيع بدأ قبل المعاهدات بسنوات. الأمثلة كثيرة، ونحن نعرف بأن عدداً من أعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في مؤتمر مدريد تخرج من جمعيات تمويل أجنبي، منها مؤسسة فافو النرويجية، فتلك معلومة عامة في الحقيقة، ونعرف أن متلقي التمويل الأجنبي في فلسطين، تحت عنوان “مثقفين”، أصدروا بياناً في 20/6/2002 ضد العمليات الاستشهادية في فلسطين.
ولكن العمل التمويلي/التطبيعي بدأ قبل ذلك بكثير، ولدي نموذجٌ موثق، وهنالك أكثر من نموذج في الحقيقة، هو نموذج “مركز إسرائيل فلسطين للبحوث والمعلومات” Israel Palestine Center for Research and Information . وقد تأسس هذا المركز كفكرة في العام 1988، وتم تأسيسه رسمياً في العام 1989 في القدس، وهو متخصص “بتطوير حلول عملية للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني”، وأترجم حرفياً من موقعه على الإنترنت. وهو يضع أسماء المشاركين فيه كاملة منها أسماء في الأردن عندنا.
ونرى حسب موقع المركز على الإنترنت أن من المسائل التي يعنى بها المركز “طبيعة اتفاق الحل النهائي الذي يجب أن يصيغه الطرفان، وتقسيم الحدود، ووضع القدس والمستوطنات، وكيفية ضمان الأمن الجسدي للمواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين من جراء أعمال العنف الذين يرتكبها الخصوم المتطرفون لعملية السلام على الجانبين… تنمية المناطق الفلسطينية بطريقة مفيدة للطرفين… تثقيف أمتين مجروحتين تجاه التعايش السلمي”. ونتابع من موقع المركز المذكور: “ولدت فكرة المركز عام 1988 في مستهل الانتفاضة الأولى حين أصبحت مهمته مد جسور التواصل بين المثقفين الإسرائيليين والفلسطينيين كمهمة عاجلة أكثر من أي وقت مضى”.
إذن اتفاقيات “السلام”، أي التطبيع، لا تأتي من فراغ، بل ثمة عمل طويل المدى أتى لينتجها كان التمويل الأجنبي أحد عناوينه وروافده الكثيرة. و”مركز إسرائيل فلسطين” فخور بإنجازاته، كما يقول على موقعه: “الأخصائيون الأمنيون المجتمعون تحت مظلتنا هم الذين حفزوا فتح قناة أوسلو منذ العام 1989”.
يتألف المركز من خمسة أقسام: قسم التحليلات الاستراتيجية، وهو يشتغل بقضايا الحل النهائي، قسم التنمية والقانون، وهو يعمل بقضايا المجتمع المدني، قسم البيئة والمياه، قسم طرق للمصالحة، وهو مشروع متعدد الجنسيات للتثقيف بالسلام، وأخيراً وحدة المركز الاستخبارية Intelligence Unit Center ، إذا كان هناك من توجد لديه شكوك حول ماهية الدور الذي يضطلع به المركز المذكور. ورب قائل: وما علاقة كل ذلك بالتمويل الأجنبي؟ والجواب على مثل ذلك السؤال المهم هو لائحة ممولي المركز المنشورة على موقعه على الإنترنت، والتي تضم نفس الجهات التي تنثر التمويل الأجنبي “غير المشروط” يمنةً ويسرةً، على ما زعموا، ومنها اليو أس إيد وسيدا السويدية والاتحاد الأوروبي وصندوق الحوار الكندي، وعدد من الدول الأوروبية من فنلندا إلى إسبانيا، بالإضافة لمؤسسات غير حكومية مثل الوقف الوطني للديموقراطية، وهو الصندوق الأمريكي الذي قدم الدعم “للمجاهدين” في أفغانستان وللانقلابات العسكرية في أمريكا اللاتينية ضد تشافيز وغيره وللحراك الجماهيري الملون في أوروبا الشرقية، ومثل مؤسسة كونراد إديناور الألمانية ومؤسسة ماك أرثر الأمريكية ومثل البنك الدولي، وغيره…
أما بعد، فهل تعتقدون أن المركز المذكور فريدٌ من نوعه؟ على العكس! إنما هو غيض من فيض. وإليكم قائمة جزئية بمراكز مماثلة اكثر أو اقل تأثيراً، تعمل منذ سنوات طوال، وقد سبق نشرها على الإنترنت:
– مركز بيغن – السادات للدراسات الإستراتيجية
– معهد هاري ترومان لبحوث تطوير السلام
– مركز جافي للدراسات الإستراتيجية
– معهد ليونارد ديفيس للعلاقات الدولية
– مركز موشي دايان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا
– مركز تامي شتابنمبنر لبحوث السلام
– معهد السياسة الدولية لمكافحة الإرهاب
– المركز العربي اليهودي في جامعة حيفا
– معهد العلاقات الإنسانية في جامعة حيفا
– معهد الدراسات العربية في جفعات حفيفا
– قسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطي في الجامعة العبرية
– مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب، باسم جافي أويا فيه
– المركز الدولي للسلام في الشرق الأوسط
– والمركز الأكاديمي “الإسرائيلي”بالقاهرة .
ويمكن أن نضيف للقائمة أعلاه “مركز بيريز للسلام” و”شبكة الشرق الأوسط” Middle East Web، و”برنامج بذور السلام” Seeds of Peace وغيرها كثير، فنحن لا نتحدث عن تكهنات هنا أو عن افتراءات، بل عن مشاريع واضحة وضوح الشمس للتطبيع وكسر حاجز العداء مع العدو الصهيوني، وفرض الرواية التاريخية اليهودية على العرب. وهنا يدخل التمويل “الإسرائيلي” المباشر على الخط في كثير من الحالات.
وفي سياق استراتيجية استخدام “القوة الناعمة” لتحقيق تمدد العولمة، لأن الشركات الدولية الكبرى تريد أن تستثمر وتتاجر عبر الحدود بدون دول وطنية تحاسبها أو تعيقها، دعونا نقدم مثالاً سريعاً جداً. فلو اخذنا الناتج المحلي الإجمالي للأردن في العام 2011 مثلاً لوجدنا أنه يعادل 31 مليار دولار. هذا يساوي قيمة النشاط الاقتصادي في الأردن، أي دخل الناشطين اقتصادياً في الأردن في ذلك العام. لكي نعرف الآن ما هي الشركات متعدية الحدود التي تمتلك مشروعاً لتخطي الدول وحواجزها السيادية فلنقارن الناتج المحلي الإجمالي الأردني بمبيعات أكبر شركة دولية لنفس العام، وهي شركة أكزون Exxon النفطية الأمريكية، وهو 486 مليار دولار. ولنلاحظ أننا نتحدث هنا عن حجم المبيعات لعام واحد هو عام 2011، لا عن القيمة الرأسمالية للشركة. وقد بلغ عدد موظفي شركة أكزون وعمالها لنفس العام أكثر من مئة ألف. فلنأخذ ثاني أكبر شركة لنفس العام وهي شركة رويال دتش شل Royal Dutch Shell، وهي شركة نفطية غازية بريطانية هولندية بلغت قيمة مبيعاتها في العام 2011 حوالي 470 مليار دولار، وبلغ عدد موظفيها وعمالها أكثر من تسعين ألفاً. ولنأخذ ثالث أكبر شركة من حيث حجم المبيعات في العام 2011 وهي شركة النفط والغاز والبريطانية برتيش بتروليوم British Petroleum، وقد بلغت قيمة مبيعاتها 375 مليار دولار. وعلى سبيل المقارنة فلنلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي المصري لنفس العام كان 230 مليار دولار حسب البنك الدولي. وهذه مجرد أمثلة على حجم عمليات تلك الشركات وكيف تقزّم الواحدة منها بلدان بأكملها اقتصادياً، فلا يرى مدراء تلك الشركات لماذا عليهم أن ينصاعوا لإرادة موظفي بيروقراطية دول لا تبلغ نصف أو ربع أو عُشر حجمها اقتصادياً!!!
فإذا تفحصنا أكبر خمس عشرة شركة دولية من حيث حجم المبيعات للعام 2011 لوجدنا تسع شركات نفط وغاز بينها. فلنأخذ منها شركة النفط والغاز الفرنسية توتال Total مثلاً. فقد بلغت مبيعاتها في العام 2011 حوالي 215 مليار دولار، وبعدها جاءت شركة أرامكو السعودية، أو شركة النفط العربية الأمريكية، بمبيعات مقدارها 210 مليار دولار في العام نفسه. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يوجد في فرنسا نفط وغاز؟ وهل في بحر الشمال نفط وغاز يفسر المبيعات الضخمة لرويال دتش شل أو برتيش بتروليوم؟! بالطبع لا! إنما هي ثرواتنا التي يسيطرون عليها، وثروات شعوب الأرض، وهذا هو مشروع الإمبريالية الحقيقي: السيطرة على ثروات الشعوب وأرضها وأسواقها وسياساتها.
الشركات الكبرى عابرة الحدود في الدول الرأسمالية هي قاطرة العولمة، لكن يوجد فوقها وخلفها قوة لا تُرى تحركها هي الكتل المالية الضخمة التي تسيطر عليها، عبر امتلاك حصص من اسهمها وقروضها، وهذا هو رأس المال المالي الدولي، المتمثل بالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية (مثل صناديق الاستثمار) والكتل المالية التي تملكها عائلات. وهنا يبرز التداخل بين رأس المالي اليهودي ورأس المال الإمبريالي، وبين مشروع الصهينة ومشروع العولمة، وبين التطبيع والتمويل الأجنبي، وتبرز مؤسسات فورد وروكفلر وغيرها التي تمثل امتداداً طبيعياً للمؤسسة الحاكمة في العالم الرأسمالي. فإذا مولت تلك المؤسسات بعض المنظمات غير الحكومية، فمن أجل مشروعها السياسي، وهو التمويل الذي لا يشكل إلا جزءاً بسيطاً من فتات الأرباح التي تحققها الإمبريالية من أرضنا ومواردنا وعرق عمالنا وموظفينا.
ومثل هذا التمويل لا يمكن فصله عن مشروع الدم الذي رأيتموه في العراق وليبيا والذي ترونه اليوم في سورية، والذي سيمتد إلى كل الوطن العربي إن لم نتصدى له بقوة.
ويمكن اعتبار التمويل الأجنبي في هذا السياق امتداداً لمشروع استخدام “القوة الناعمة”، أي استخدام وسائل التأثير الإعلامي والثقافي والسياسي في تحقيق الأهداف الإمبريالية باعتبارها أقل كلفة من “القوة الخشنة” المتمثلة بالحروب والعمليات الخارجية والاغتيالات وما شابه. على سبيل المثال، اطلقت وزارة الخارجية الأمريكية عام 2001 مشروعاً مهماً جداً هو “مبادرة الشراكة الشرق أوسطية” Middle East Partnership Initiative الذي يتألف من حوالي 350 برنامجاً ممولاً، تحت عنوان “الدبلوماسية العامة”، بغرض اختراق الجمهور العربي والإسلامي، كبديل للدبلوماسية التي تجري بين الدول. وقد تلقى عشرات آلاف المواطنين العرب دورات في “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان” في سياق تلك البرامج.
ولا يأتي مثل هذا البرنامج بلا خلفيات، بل كثيراً ما استخدمت الولايات المتحدة “القوة الناعمة” بالتوازي مع القوة الخشنة في سعيها للسيطرة على العالم. مثلاً، لو نظرنا لما يسمى “مؤتمر الحرية الثقافية” الذي أسسوه عام 1950 للتصدي للشيوعية في أوروبا الغربية أيديولوجياً وثقافياً، من خلال واجهات لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لوجدنا أن كثيراً ممن عملوا في تلك الواجهات لم يكونوا يعلمون أنهم مجرد أدوات بيد الإمبريالية. وقد وثقت الكاتبة البريطانية فرانسيس ستونور سوندرز جيداً، في كتابها “من يدفع للزمار/ الحرب الباردة الثقافية”، دور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليس فقط في خلق واجهات ثقافية، بل في إنشاء تيارات كاملة في الموسيقى والرسم والأدب والشعر، أو في تشجيعها، لأغراض سياسية. مثلاً، هنالك ما وثقته سوندرز عن تشجيع موسيقى الهارد روك لمحاربة التثقيف الجماهيري بالموسيقى الكلاسيكية في الدول الاشتراكية سابقاً التي اعتبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أنها تسهم بتنمية حس تماثلي عند الجمهور. وهنالك ما وثقته سوندرز عن تشجيع الرسم التعبيري التجريدي Abstract Expressionism بأقصى صوره الرافضة لوجود شكل أو خطوط واضحة في الرسم، وكذلك تشجيع الشعر الحر…
وعلى نفس المنوال، نرى اليوم عدداً كبيراً من مواقع الإنترنت والمنابر والمؤتمرات التي برزت كواجهات ل”مبادرة الشراكة الشرق أوسطية” من أجل التثقيف ب”الديموقراطية” و”حقوق الإنسان”. وحسب دراسة روسية سبق أن ترجمت خلاصتها إلى العربية فإن تلك المنابر نجحت بالوصول إلى مئات آلاف المواطنين العرب، ويمكن إيجاد تلك الترجمة على الرابط التالي:
http://freearabvoice.org/?p=1117
وقد تبين في النهاية أن التحليلات الروسية والصينية عن دور برامج التمويل الأجنبي المنبثقة عن “برنامج الشراكة الشرق أوسطية” الأمريكي في صياغة “الربيع العربي” ليس ببعيدٍ عن الحقيقة. وقد كانت كوندوليسا رايس، مستشارة الأمن القومي ثم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، قد خرجت بتصريح علني عقب نجاح الثورات الملونة في اوروبا الشرقية تدعو فيه لزيادة تمويل المنظمات غير الحكومية. ولدينا هنا في الأردن مثالٌ أخر عن العلاقة بين التمويل الأجنبي والتطبيع فيما حدث بين 9 و11 حزيران في العام 2008 عندما رعت “مبادرة الشراكة الشرق أوسطية” مؤتمراً في عمان، تحت عنوان “قادة المجتمع المدني يتبادلون الخبرات”، بإشراف خبراء من وزارة الخارجية الأمريكية، شارك فيه شباب عربٌ من اقطار عربية متعددة من اليمن للمغرب، بالإضافة لشباب “إسرائيلي”!! وهذا موثق طبعاً.
ففي منطقتنا تحديداً يصبح التطبيع جزءاً أساسياً من لعبة التمويل الأجنبي. وحتى لو لم توجد “شروط مسبقة”، فما دامت اجندة المموِل معروفة مسبقاً، فليس ضرورياً أن يفرض شروطاً، بل يصبح قبول التمويل قبولاً ضمنياً بالشروط. وليس ضرورياً أن تكون مثل تلك الشروط حاضرة في كل مثال صغير، في كل حضانة للأطفال أو دورة تدريبية أو حملة تثقيف صحي، فما يحدث في النهاية هو أن المموِل يفرض أجندته، والمتمول سوف يحرص على استمرار التمويل، مما يدفعه للتغاضي عن أجندة الممول بشكلٍ أو بأخر. فالمهم هو السياق والنتيجة. وربما يحرص المموِل على إخفاء اسمه لإظهار التطبيع كعمل محلي طوعي كما في حالة اليو أس إيد، أو وكالة التنمية الأمريكية، والكراسين التطبيعيين الذين نشرتهما للطلبة من سن تسعة إلى اثني عشر عاماً عبر جهات رسمية أردنية:
http://nozion.net/?p=1226
إذن السؤال الحقيقي يجب أن يكون: هل هناك تمويل أجنبي غير مشروط؟ ففي مجتمعات راسمالية غربية تقوم على مبدأ الربح لا بد أن نتساءل عن أهداف التمويل الأجنبي المحددة، لا إذا ما كان مشروطاً أم لا. ففي الولايات المتحدة وحدها يوجد مئات آلاف المشردين الذين يعيشون بلا مأوى أو منزل، فلماذا إذن تنفق حكومة الولايات المتحدة والمؤسسات الأمريكية مئات ملايين الدولارات على تمويل المنظمات غير الحكومية حول العالم، في أوروبا الشرقية مثلاً، خاصة في روسيا، بدلاً من إنفاقها على الأمريكيين المشردين؟!
والحقيقة أن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية هو جزءٌ أساسي من عمل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لزعزعة استقرار الدول التي يراد إضعافها وتفكيكها، كما نرى من وثيقة ترجمتها عام 1999 بعنوان “الترويج للديموقراطية في يوغوسلافيا: عناصر أساسية للدعم المالي” صدرت في واشنطن في 16/12/1998:
http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/TamweelAjnabeeLemonathamatMadaneyyeh.htm
وقد لا تجد في تلك الوثيقة شروطاً واضحة في كل حالة، فهنالك 5 مليون دولار لقطاع التعليم، و10 مليون دولار للأحزاب السياسية، ومليوناً للقضاء المستقل، الخ… بل قد يكون الهدف، كما جاء في مقدمة الوثيقة، هو إقامة أوسع الصلات مع عناصر المجتمع المدني وإيجاد مؤسسات بديلة للدولة، ضمن السياق الذي تناولناه في مقدمة هذه الورقة، وإيجاد جيل جديد من القادة الذين يحترمون حكم القانون والتسامح، والأهم، إقامة دولة صربية ديموقراطية. ومن الواضح أن يوغوسلافيا كانت تتألف من صرب وكروات وبوسنيين، فالحديث عن دولة صربية ديموقراطية يعني فقط تفكيك يوغوسلافيا في سياق الحديث عن “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان”!
النقطة الأخرى أن جماعة التمويل الأجنبي يتهموننا عندما نقدم خطابنا المناهض للتمويل بأننا متحالفون مع الدول الديكتاتورية ضد “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان”، ويعيبون علينا ذلك ونحن معدودون من المعارضين زاعمين أننا نؤيد بمثل هذا الموقف تسلط الأجهزة الأمنية وتغولها. والحقيقة أننا في ظل مشروع العولمة لتفكيك الدول، أي دول، وأي حالة قوة مركزية، خاصة إذا كانت خارجة عن طوع الإمبريالية، يجب أن نميز ما بين الدولة من جهة، كمؤسسة عامة ترعى القضايا العامة وكبنية تحتية تحفظ البلد من التفكك، وما بين النظام السياسي بما يمثله من نخبة حاكمة وسياسات وأدوات توظف الدولة والمؤسسة العامة لمصالح لا تنسجم مع مصلحة الشعب من جهة أخرى. فما نعارضه حتى النهاية هو النظام، أما الدولة بالمجرد، فنحن غير معنيين على الإطلاق بضربها وشطبها بناء على برنامج العولمة، بل نريد دولاً وطنية قوية ومركزية تستطيع أن تواجه مشروع العولمة. نريد دولاً تعبر عن المصلحة العامة بشكلٍ أفضل، أي دولاً تتبنى مشروع الاستقلال والتنمية المستقلة والتحرر الوطني، وفي النهاية، دولة عربية واحدة تعبر عن المصلحة القومية للشعب العربي.
ولنلاحظ أننا لا نستبدل الدول القطرية هنا بدولة وحدة عربية واحدة، بل بمشروع تفكيك يتخذ من “الديموقراطية” و”حقوق الإنسان” ستاراً، كما رأينا في مثال يوغوسلافيا أعلاه، وأن الهجوم على الدولة القطرية لا يأتي من مشروع أكثر استقلالية ووحدوية منها، بل ان المطروح هو العودة إلى الخلف، إلى ما قبل الشعب والمواطن… ونلاحظ أن المدافعين عن التمويل الأجنبي، كبعض الإسلامويين تماماً، يعادون الدولة بذريعة معاداة النظام، ولكنهم عندما يستلمون السلطة يفككون الدولة ويبقون على النظام، أي نظام التبعية للامبريالية والخارج والتطبيع. فنحن إذن نعارض النظام دفاعاً عن الدولة، عن وطنيتها تحديداً، أما هم فيعارضون الدولة ويحافظون على النظام. وذلك هو الفرق الرئيسي بيننا وبينهم. وفي النهاية يتمثل البرنامج القومي العروبي بتأسيس دولة عربية واحدة من المحيط إلى الخليج مركزية، لا فدرالية ولا كونفدرالية، وهو ما يعني الانتقال من الدول القطرية العربية إلى الدولة القومية العربية الواحدة، وشتان ما بين هذا وبين تفكيك الدولة القطرية العربية إلى دويلات.