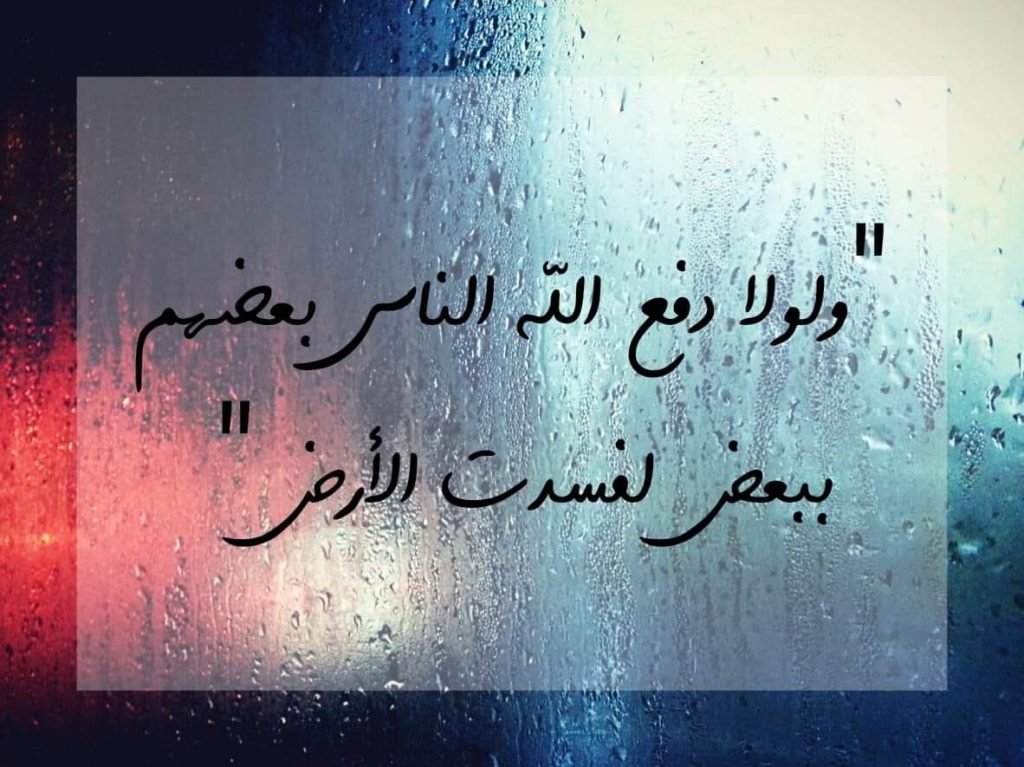
بدأ موسم الحجّ، ومرّ أمامي أمس، تصريح وزير الحجّ السعوديّ الذي يقول فيه: “الحج للعبادة، لا للشعارات السياسيّة”، ما دفعني لإعادة كلام قديم، فيه رابط مع أحداث اليوم.
ما هو الحج؟ رمزية طقوسه ومعانيها؟ هل حجُّ أيامنا هذه له مضمون ما؟ (الإجابة جزء من مقالة كتبتها منذ بضع سنوات عن تاريخية السيرة)
عرف العرب -قبل الإسلام- نوعين للحج، الأكبر والأصغر، وهما متباينان، رغم أن كليهما ينتهي بحلق الشعر والتضحية بالأنعام، ويظهر الفرق بينهما في ما يلي:
1. الحج الأكبر ليس إلى مكّة، لذلك لم يكن فيه طواف حول الكعبة، ويقع في أشهر معلومات، ذو القعدة، ذو الحِجّة ومحرّم، كان يضم وافدين من قبائل مختلفة، ومستقلٌّ عن رقابة قريش تماما، إلى وقت استلحاق مؤسسة الحج بالإسلام في السّنة العاشرة للهجرة.
2. الحج الأصغر (العمرة) يقع في مكة، وفيه طواف حول الكعبة، وكان يقام في فصل الربيع عادة.
تميّزت المنطقة المحيطة بمكّة بتعدد الأماكن الدينيّة، فهناك الحرم، جبل عرفات، المزدلفة، مِنى، نخلة القريبة من مكّة وفيها مقر الآلهة “العُزّى”، إضافةً للأسواق الثلاثة الكبرى المرتبطة بالحج (ذو المجاز، عكاظ، مِجَنّة).
كانت العرب تحج وتلبّي، وأقتبس من “جواد علي” في كتابه “المفصّل في تاريخ العرب” بعضا من هذه التلبيات:
“كانت تلبية كندة وحضرموت: لبيك لا شريك لك، تملكه، أو تهلكه، أنت حكيم فاتركه…
وكانت تلبية غسان: لبيك رب غسان، راجلها والفرسان .. وكانت تلبية بجيلة: لبيك عن بجيلة في بارق ومخيلة.. وكانت تلبية قضاعة: لبيك عن قضاعة، لربها دفّاعة، سمعًا له وطاعة…
وكانت تلبية جذام: لبيك عن جذام، ذوي النهى والأحلام.. وبني النمر إذ يقولون: لبيك يا معطي الأمر، لبيك عن بني النمر… جئناك في العام الزمر، نأمل غيثًا ينهمر… يطرق بالسيل الخمر…” (إلى هنا ينتهي الاقتباس)
في الظاهر، لا تختلف طقوس الحج الأكبر الجاهلي عن ذلك الحج في الإسلام، إلا أن رمزية الطقوس هي التي اختلفت بشكل جذري، وهي التي يأخذ فيها الراحل “هشام جعيّط” برأي المؤرخة “جاكلين الشابي”، ويلخّصها على الشكل التالي:
+++ كانت العرب تقف في عرفة (جبل عرفات) إلى قبل غروب الشمس بقليل، وكانت تلك الوقفة مصحوبة بابتهالات وعبارات ما. رمزية الوقفة تتلخص في الانتظار تحت حرارة الشمس اللاهبة، كنداء يوجهه الحجيج الواقفون لهذا الجرم السماوي (الإله)، أن تخف وطأته كي تنزل أمطار الخريف.
+++ بعد الوقفة في عرفات، يبدأ الحجيج حركتهم نحو المزدلفة، بما يسمونه الإفاضة، ولَإِنْ كانت الوقفة على علاقة بالشمس، فإن الإفاضة متصلة بالمطر، فما الفيض والإفاضة إلا ارتباط بالمياه، وفي حركة الحجيج محاكاة لجريان سيل الأمطار التي يتمنّونها، ولأجلها وقفوا.
+++ بعد الإفاضة الأولى، ينطلق الحجيج إلى الأنصاب في “مِنى” متابعين إفاضتهم، تلك الموصوفة في السياق القرآني “كأنهم إلى نُصُبٍ يفيضون”، وهناك يرمون الجمار (الحصى) في مكان واحد مقدس، احتراما وإجلالا للآلهة. في الأنثروبولوجيا العربية يعد رمي الحصى عمل بِرٍّ إزاء الآلهة، ولا علاقة له بالعنف الذي يعتقده البعض أن رمي الحصى هو رجم للشيطان!
+++ الطقس الأخير هو النّحر، موجود في كل الديانات القديمة، ويقع في “مِنى”، ويعبّر عن أزمة بين الجماعة والطبيعة (انتظار المطر)، لا تنفرج هذه الأزمة إلا بإراقة دماء الأنعام لثلاثة أيام يكون فيها احتفاء واحتفال تسمى (أيام التشريق)؛ والتشريق في اللغة، يعني تشريح اللحم وتجفيفه، حتى يتسنى لهم تخزينه وتناوله لاحقا.
إن الحج الجاهلي مرتبط بالعبادات الشمسية المتصلة بعقيدة الخصب الأولى، وهو طقس مهيب إذ يجري في الهواء الطلق؛ فلا تكتنفه معابد مغلقة، صغيرة كانت أم كبيرة، ولطقوسه رمزية تعبر عن حوار مع الطبيعة. ما فعله الإسلام بإدخال مؤسسة الحج في شعائره، أنه غير من طقوسه قليلا، فدمج الحج الأصغر بالأكبر، وأقحم فيه الطواف حول الكعبة، كما غير من وقت الإفاضة إلى المزدلفة ليجعله بعد غروب الشمس، ومن المزدلفة إلى مِنى قبل بزوغها، ليقطع صلة هذه الحركات بالشمس. بعبارة أخرى، أنه أفرغ هذه الطقوس من مضمونها الأصلي مع الإبقاء على الشكل الحركي لها، والمؤدّى أنه يقطع ارتباطها بالسلوك الوثني، فيجعله خالصا لله الذي دعا النبي العربي الكريم لعبادته، كرمز لتوحيد القبائل المتفرقة؛ وقد يتساءل المرء، لماذا لم يلغ الإسلام الحج من أساسه كما فعل مع مؤسسات جاهلية أخرى؟
القاعدة الأساس أن الحج مؤسسة عربية عامة في الجاهلية، عليها إجماع واتفاق، أي أنها عامل وحدة رغم كل الاختلافات القبلية السائدة بين العرب آنذاك، ولأنّ في طقوسها ما يعبر عن التكافل والتعاضد، ولأنها تجري في أوقات حرام، حيث يكون الأمن حاضرا.
لكن أسئلة اليوم ما زالت تفرض نفسها؛ هل التكافل حاضر؟ هل بقي الحج عاملا للوحدة وتحقيق الأمن؟! هل الأمن موجود أصلا؟ لماذا هو محتَكَر لفئة ما، مسيّس لأجلها؟ وهل قضيّة الدم تختزل في باب السياسيّة؟!
لا تتسرّع الإجابة، فكّر قليلا فيمن يضع سلاحه ودمه مع أهل فلسطين، وانظر “الأمن” الذي حققه من تخلى عن قتال العدو، ثم تذكّر الأثر المروي عن النبي وهو يطوف بالكعبة ويقول: “ما أطيبك، وأطيب ريحك! ما أعظمك، وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك؛ ماله، ودمه”.
عن صفحة الرفيق محمد العملة





